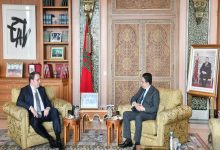في الذكرى الثانية لاعتماد الأمم المتحدة يوم الأخوة الإنسانية يوما عالميا.
يعن لنا التساؤل: هل يمكن اعتبار وثيقة الأخوَّة الإنسانية، التي صدرت عام 2019 من الإمارات، النسخة الأحدث في مسار الحلم الإنساني الكبير؟
أغلب الظن أن ذلك كذلك، ولا سيما أن الوثيقة تتجاوز كثيرًا جدًا مسألة الحوار، إلى العيش الإنساني الأخوي الواحد.
يمكن القطع بأن جذور التأصيل الفكري والإيماني لهذه الوثيقة قد تبدَّت في السطور الثلاثة الأولى، وفيها أن “الإيمان يحمل المؤمن على أن يرى في الآخر أخًا له، عليه أن يؤازره ويحبه، وانطلاقًا من الإيمان بالله الذي خلق الناس جميعًا وخلق الكون والخلائق وساوى بينهم برحمته، فإن المؤمن مدعو للتعبير عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله، وبتقديم العون لكل إنسان، ولا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزًا”.
هي إذًا ليست وثيقة مجمعية كنسية كسابقتها، ولا وثيقة إسلامية مثل وثيقة “المواطنة” التي صدرت عن الأزهر الشريف قبل بضعة أعوام، إنها مسار إنساني للخليقة كافة، وإنْ رسم خطوطه الڤاتيكان والأزهر الشريف برعاية من دولة الإمارات وتحت سماواتها، مسار يسعى لانتشال تلك الأخوَّة، التي أرهقتها سياسات التعصب والتفرقة، التي تعبث بمصائر الشعوب ومقدَّراتهم، وأنظمة التربح الأعمى، والتوجهات الأيديولوجية البغيضة.
ما يميز “وثيقة الأخوة” عن سائر الوثائق والنداءات المشابهة أمران:
الأول: هو أننا أمام دور لرجال الدين مغاير لأدوار تاريخية كانت أدوات للتفرقة بدلًا من التجميع ولمِّ الشتات، رجال دين أياديهم متضافرة لخير الإنسانية، سهامهم ورماحهم أضحت مناجل للزرع والحصاد، لا للموت والقتال.. رجال دين يطالبون، انطلاقًا من مسؤولياتهم الأدبية والدينية، أنفسهم وقادة العالم، وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي، بالعمل جديًا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل الفوري لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حاليًا من حروب وصراعات وتراجع مناخي، وانحدار ثقافي وأخلاقي.
والثاني: هو أن مجال المناداة بها لا يتوقف عند حدود الكنائس والمساجد، والمطالبون بتفعيلها ليسوا من القساوسة أو الشيوخ فقط، إنها تتجاوز ضيق الأيديولوجيا إلى رحابة الإبستمولوجيا، فهي تتوجَّه للمفكرين والفلاسفة، ولرجال الدين والفنانين، وللإعلاميين والمبدعين، في كل مكان، ليعيدوا اكتشاف قيم السلام والعدل، والخير والجمال، والأخوَّة الإنسانية والعيش المشترك، وليؤكدوا أهميتها طوقَ نجاة للجميع، وليسعدوا في نشر هذه القيم بين الناس في كل مكان.
وثيقة الإمارات للأخوَّة الإنسانية، وهي تعتمد كل ما سبقها من وثائق عالمية، تنبه على الأمر الذي أشرنا إليه، أي ما للأديان من دور مهم في بناء السلام العالمي، وعليه فإنها تؤكد القناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وتكريس الحكمة والعدل والإحسان، وإيقاظ نزعة التدين لدى النشء والشباب لحماية الأجيال الجديدة من سيطرة الفكر المادي، ومن خطر سياسات التربُّح الأعمى، واللا مبالاة القائمة على قانون القوَّة، لا على قوة القانون.
والثابت أن مكتسبات وثيقة الإمارات الحقيقية هي أنها بيَّنت بجلاء أن الأديان يمكن أن تكون في خدمة السياسات بمودة ورقي وتكريس لفعل الخير العام، فهي تتناول إشكالية الحرية بوصفها حقًّا أصيلًا لكل إنسان، اعتقادًا وفكرًا، تعبيرًا وممارسة، وترى أن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، التي تحاصر جزءًا كبيرًا من البشر.
“في هذا العصر حيث تعَدُّ الأديان مصدرًا للصراعات، أردنا أن نعطي إشارة جديدة واضحة ومقدَّرة، أنه يمكن أن نلتقي وأن نتبادل الاحترام، وأن نتحاور”.. هكذا تكلم البابا فرنسيس، مضيفًا في لقائه الأسبوعي الأول بعد عودته من الإمارات، في ساحة القديس بطرس: “شكَّلت هذه الزيارة خطوة مهمة إلى الأمام في الحوار بين الأديان، والالتزام بتعزيز السلام في العالم على أساس الأخوَّة الإنسانية”.
للبابا والشيخ حقًا أن يفاخرا ويجاهرا بما قدَّماه للعالم، فصيغة الوثيقة تؤكد أنه من خلال التعاون المشترك بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف سيمضي العمل على إيصال هذه الوثيقة إلى صناع القرار العالمي والقيادات المؤثّرة ورجال الدين في العالم، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنيَّة ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية وقادة الفكر والرأي، ونشر ما جاء بها من مبادئ على المستويات الإقليمية والدولية كافة، وترجمتها إلى سياسات وقرارات، ونصوص تشريعية، ومناهج تعليمية ومواد إعلامية.
ينشأ السلام العالمي من التربية عليه أولًا، ولهذا تناشد الوثيقة المؤسسات التعليمية والتربوية من أجل المساعدة في خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام، وتدافع عن المقهورين والبؤساء.
والثابت أنه لا يمكن لأي صاحب نظرة موضوعية عادلة أن يغفل الاستحقاقات التاريخية الإيجابية للزيارة والمؤتمر والوثيقة على العالم الإسلامي، وقد بدا وكأن هناك صورة مغايرة نجحت الإمارات في رسمها للإسلام والمسلمين، بخلاف الكثير جدًا من الصور الزائفة المنتشرة حول العالم، ولا سيما في سياقات ظاهرة “الإسلاموفوبيا”.
في مطار “أبوظبي الدولي” كان العناق الحار بين البابا وشيخ الأزهر صورة أبلغ بل أنفع وأرفع من مئات ملايين الدولارات، التي كان لها أن تنفق من أجل إعطاء ملامح للإسلام السَّمْح المعتدل، المحبِّ، الباذل، القابل للآخر.
الذين سيقدَّر لهم في العالم الغربي قراءة أحداث زيارة البابا والشيخ وأوراقها سيتساءلون حكمًا عن مآلات بعيدة عن سرديات “القاعدة” و”داعش”، مآلات جعلت من قادة الإمارات العربية المتحدة يفتحون قلوبهم وعقولهم، قبل أن يفتحوا مدينة “زايد الرياضية” لإقامة أول قُدَّاس كاثوليكي على أرض الجزيرة العربية، بقيادة الحبر الروماني الأعظم، وعليه يستقيم التساؤل الخلَّاق: أليس هؤلاء أصحاب رؤية إيمانية إنسانية غير منحولة، ولا علاقة لها بذرائع الإسلاموفوبيا وتبعاتها حول العالم؟
هل انتهت زيارة البابا والشيخ إلى الإمارات، في أعقاب مغادرتهما لأرضها التي وصفها فرنسيس بأنها “مباركة”؟.. في تقدير صاحب هذه السطور أنها بدأت للتو، وأن المسيرة قد انطلقت، وفي حاجة إلى عمل إنساني كبير للمضي قدمًا إلى الأمام، وهذا ما استشرفه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أمر بتخصيص مساحة أرض في جزيرة “السعديات” لتشييد معلم حضاري جديد، يطلق عليه اسم “بيت العائلة الإبراهيمية”، ويرمز إلى “حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في مجتمع الإمارات