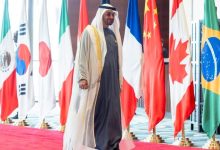أنقرة-تل أبيب.. كراهية مستقرّة وفوضى مستمرّة


لم تحمل تركيا للعالم العربيّ أيَّ خير في ماضيها أو حاضرها، بل على العكس من ذلك تماما، فقد أثبتت التجربة التاريخيّة تعاونها وتنسيقها مع القوى المُعادِية للعرب، وفي المقدمة إسرائيل.
كانت الأخيرة دائما وأبدا تبحث لها عن حلفاء في محيطها الجغرافيّ، حلفاء لا يهتمّون لشأن العالم العربيّ، ولا لمصالح شعوبه، بل ربّما يحملون له أحقادا تاريخيّة تزيد من أوضاعهم المتردّية، ما يجعل شعوبهم تعيش القلق في النهار والأرق في الليل.
علاقة أنقرة مع تل أبيب هي أقرب ما تكون إلى الزواج الخفيّ غير المُعلَن، وإن كان هذا أمرا ينطلي على العوامّ، أما الذين لديهم علم من كتاب الأبعاد الماورائيّة فشأنهم في ذلك مختلف.
قبل خمسين عاما، وتحديدا في 28 مارس من عام 1949 كانت تركيا أوّل دولة ذات أغلبيّة مسلمة تعترف بقيام دولة إسرائيل في أروقة الأمم المتحدة، والسؤال: لماذا؟
يتبيّن لنا من تفكيك هذه الثنائيّة الضارّة أنّ البراجماتيّة المعادية للعرب ضاربة جذورها في البلدين، فالأتراك الذين خرجوا من الحرب العالميّة الثانية مجروحين منكسرين، قد رؤوا في تل أبيب أقرب الطرق إلى قلب واشنطن سيّدة قيصر الجديدة المنتصرة في الحرب، الأمر الذي تمّتْ ترجمته على أعلى مستوى حين زار رئيس وزراء تركيا في يونيو 1954 واشنطن، وهناك صَرَّحَ بشكل علنيّ أنّه حان الوقت ليعترف العرب بحقّ إسرائيل في البقاء.
كانت مواقف تركيا دائما مساندة لإسرائيل ولو على حساب العرب، ومثال آخر يوضّح لنا صدقيّة ما نقول به، ففي صيف 1951 كانت تركيا ضمن المصطفّين في مجلس الأمن مع الدول الرافضة لتقييد الملاحة الإسرائيليّة في قناة السويس.
لم تكن إسرائيل تتطلّع إلى تركيا محبَّة وكرامة، بل بحثا عن قوى إسلاميّة غير عربيّة، وحتّى لا تبدو قضيّة صراعها في المنطقة قضيّة إسرائيليّة – إسلاميّة، بل إسرائيليّة – عربيّة، وهناك فارق كبير بين الأمرين، بمعنى أنّها لا تريد أن تفقد بقيّة العالم الإسلاميّ الذي يمكنها أن تقيم مع بعض دوله علاقات بعينها.
لماذا نستدعي هذه العلاقة سيّئة الذكر في مثل هذا التوقيت؟
باختصار غير مُخِلّ لتأكيد نوايا الكراهية المستمرّة والعمل على نشر الفوضى المستقرّة من جانب أنقرة وتلّ أبيب في العالم العربيّ، وما نشرته بعض المواقع الروسيّة مؤخَّرا يدلِّل على أن التعاون الأمنيّ والاستخباريّ بين البلدين ماضٍ على قدم وساق، بهدف واحد وهو دعم القلاقل والاضطرابات في الشرق الأوسط، من خلال تشجيع الحروب الأهليّة بين العرب وبعضهم البعض وتعميق الانقسامات الطائفيّة والداخليّة بين العرب أنفسهم.
التحليلات التي تملأ سماء المعلومات توضّح لنا درجة التعاون العسكريّ بين الجانبَيْن، لا سيّما في سوريا وليبيا، أمّا سوريا فهي تكاد تكون دولة الطوق الأخيرة المتبقّية من حول إسرائيل، فأمّا ليبيا فهي المشروع الأحدث للتنسيق التركيّ الإسرائيليّ المشترك، وما يراه المرء من طائرات مُسَيَّرة في سماوات ليبيا، هو نتاج هذا التعاون فطائرة “بيرقدار” التركية، هي الوجه الآخر من نظيرتها “أيروستار وهيرون” الإسرائيليّة.
تل أبيب تدعم أنقرة سرّا وعلانية لتظلّ الفوضى متفشيّة في سوريا ولا تعرف الهدوء أو إعادة البناء، الأمر الذي لا يصبّ في صالحها ومصالحها، وهي مَنْ تحتلّ الجولان، بدعم أمريكي يعترف بسيادتها على مرتفعاته.
ماذا عن ليبيا؟ ليس في الأمر سرٌّ أن ليبيا هي المرحلة التكتيكيّة للخراب والفوضى، في حين يبقى الهدف الاستراتيجيّ هو مصر، والتي تبقى بحسب النصوص التوراتيّة الرعب الأكبر لإسرائيل طوال تاريخها في القديم والحديث.
ولعلّ المتابع لتحرّكات تركيا في المتوسط عسكريّا، وأوهامها بالنسبة للغاز، بل تحالفها مع جماعة الوفاق الإرهابيّة يتساءل: “لماذ تصمت إسرائيل على هذا كلّه؟ الجواب المؤكّد حتما لها مصلحة بعينها هناك تتخفّى وراء غبار معارك الأصوليّين على الأرض هناك.
هناك حبل سُرّيّ لا يغيب عن الأعين بين أنقرة وتل أبيب، وهو العلاقة القديمة الجديدة بين الأصوليّات الإسلامويّة وحركات الإسلام السياسيّ، وبين التيارات الصهيونيّة التاريخيّة، وكلاهما يجمعهما عداء واضح لفكرة العرب والعروبة، ويهدفان معا إلى إنهاء أيّ صحوة عربيّة، وما تعانيه مصر تحديدا في هذا الإطار من تركيا واضح وضوح الشمس في ضحاها، فأنقرة هي التي ترعى فلول الإرهابيّين الإخوان، وتفتح أراضيها أمامهم، والآن تمضي في مشروع أوسع وأكبر من الدعم الأيديولوجيّ، متّجهة إلى التنسيق اللوجستيّ على الأرض وفي البحر.
هناك في العلاقة بين تركيا وإسرائيل حبل سُرّيّ جديد غير واضح للعيان حتّى الساعة، لكنّه حتما سيتجلّى عمّا قريب، عنوانه الصين، فإسرائيل تتهيّأ بشكل أو بآخر ولو في المدى المتوسّط وليس القريب لفكّ تعاقدها الرسميّ مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وهذه قصة أخرى تحتاج إلى قراءة جديدة، لكن باختصار غير مُخِلّ، لا تضمن الأجيال الإسرائيليّة القادمة بقاء الأجيال الأمريكيّة اللاحقة على ولاء الآباء المؤسّسين والأجداد للدولة العبريّة، في ظلّ متغيّرات التاريخ، والتحلّل من الرؤى الدوجمائيّة التي شكّلَتْ روح وعقل المسافة من واشنطن إلى تل أبيب، ولهذا تختار الصين كقوّة إمبراطورية قادمة لا محالة.
الأمر نفسه ينطبق على تركيا التي تناوش حلف الأطلنطيّ بإمكانية هجره والارتماء في الأحضان الصينية التي توفّر المزيد من الردع النقديّ على الأقلّ للأتراك، وأمورا أخرى تصبّ في صالح تمرُّدهم على أمريكا.
المشهد التركيّ – الإسرائيليّ، لم يكن خافيا عن أعين الأمريكيين، وما زيارة بومبيو الأخيرة لإسرائيل إلا محاولة لقطع الطريق على الغزو الصينيّ الناعم لاسرائيل والتي تتهيّأ لمرحلة عالميّة مغايرة لما بعد فقدان أمريكا مكانتها الدولية المطلقة.
يكتب “روي جلعاد” القائم بالأعمال الإسرائيليّة في أنقرة على موقع “هاليميز” التركيّ قبل أيّام داعيا إلى المزيد من التنسيق الإسرائيليّ التركيّ والتوحد ضدّ الأعداء المشتركين، وفي الخفاء يلتقي سرّا رئيس جهاز الموساد “يوسي كوهين” رئيس الاستخبارات التركيّة “حاقان فيدان”، مرّتين في أقلّ من عشرة أشهر لمناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا وعموم الشرق الأوسط، فيما طائرات العال الإسرائيليّة تحطّ في مطارات إسطنبول حاملة الدعم للأتراك.
تركيا الأبوكريفيّة تتشدّق بالقضيّة الفلسطينيّة، وهي أوّل من يخدم إسرائيل من خلال دعمها لحركة حماس في قطاع غزة، وهذا ما تريده تلّ أبيب، أي استثمار الانفصال بين الفلسطينيّين، كي لا تكون هناك دولة فلسطينيّة موصولة الأطراف.
الخلاصة، لا يُجتَنَى من الشوك تينٌ أو من الحَسَك عنبٌ، كذلك فلينظر الناظر إلى أنّه لن تكون أنقرة وتلّ أبيب إلا وراء كلّ المخاوف والقلاقل في الشرق الأوسط أمس واليوم وغدا.
نقلا عن العين الإخبارية