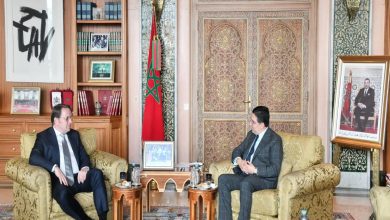أتباع الولي الفقيه يطرقون أبواب المحكمة الاتحادية


المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق، وظيفتها تفسير مواد الدستور والرقابة على انسجام التشريعات مع مواده، والبت في القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تتخذها السلطة الاتحادية.
كما تنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات، وتصدِّق على نتائج الانتخابات بعد حسم النزاعات، بالإضافة إلى وظائف أخرى، منها البت في الشكاوى المقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والفصل في النزاعات بين الحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، أو بينها وبين الحكومة الاتحادية.
مازالت المحكمة الاتحادية تعمل وفق القرار رقم 30 الصادر في 17 مارس/آذار عام 2005 عن الحكومة المؤقتة، أي قبل إقرار الدستور الدائم، لكن مشكلتها أن قانونها الحالي ينص على أن تجتمع بكامل أعضائها التسعة، لكن غياب ثلاثة منهم، بسبب الموت أو التقاعد، قد شل عملها كليا إذ لا تستطيع أن تعقد جلساتها حسب القانون الذي شُكِّلَت بموجبه، ما أوجب تشريع قانون جديد لها أو تعديل قانونها الحالي.
لكن المشكلة التي طرأت بخصوص تشريع هذا القانون هي أن الجماعات الموالية للولي الفقيه في البرلمان العراقي تصر على أن يكون أربعة من أعضاء المحكمة من الفقهاء المسلمين، وأن قرارات المحكمة يجب أن تصدر بالإجماع، أي أن كل عضو فيها يتمتع بحق النقض (الفيتو)، ما يعني أن أعمال البلد وقراراته المهمة سوف تتعطل إن قرر أيٌ من الفقهاء الأربعة نقض قراراتها تحت ذريعة مخالفتها شرع الله! إن أُقِرَّ هذا القانون، فلابد أن تختار هذه الجماعات “فقهاء” متحزبين يأتمرون بأمر الولي الفقيه الإيراني، وهذا يعني أن مصير العراق وقوانينه وانتخاباته وحكومته وسيادته واستقلاله وحريات شعبه واقتصاده، سيقررها النظام الثيوقراطي الإيراني، مستعينا بجماعات مسلحة لا تنتمي في أعماقها إلى العراق.
المادة (92-أولا) من الدستور تنص على أن “المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا”، وهذا النص واضح لكل ذي عين، ولا يمكن تأويله، وهو يعني أن المحكمة تتكون من قضاة فحسب، شأنها شأن أي محكمة في العالم، ولا يمكن أحدا أن يكون عضوا فيها إن لم يكن قاضيا، أي لا مكان لرجال الدين بين أعضائها.
المادة (92-ثانيا) تنص على أن “المحكمة الاتحادية العليا تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء في القانون، يًحدَّد عددُهم وتُنظَّم طريقةُ اختيارهم بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”. ومع الاعتراف بضعف هذا النص، كونه يسمح للمغرضين بتأويله، لكن القول بأن يكون الفقيه عضوا في محكمة يجافي منطق القانون والقضاء، خصوصا في هذا العصر، الذي أصبحت فيه مواصفات القاضي أكثر دقة وصرامة، ولم تعد عائمة كما كانت في الأزمان الغابرة.
ومع كل هذه الصرامة والدقة التي ترافق أحكام القضاء، هناك محاكم استئناف وتمييز لإعادة النظر في أحكام القضاة للتأكد من صوابها وعدالتها. ولأن المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، فإن من الضروري أن يتمتع أعضاؤها بكفاءة عالية وخبرة طويلة. المادة الدستورية، رغم ضعفها، تنص على وجود خبراء في الفقه الإسلامي، والمقصود “مستشارون” للمحكمة، تستعين بهم في مجال تخصصهم، وليسوا قضاة. القضاة فقهاء حسب المبدأ المعروف (كل قاضٍ فقيه وليس كل فقيه قاضياً).
أتباع الولي الفقيه في البرلمان يأولون هذه المادة لتجعل من الفقهاء أعضاءَ في المحكمة، رغم أنهم ليسوا قضاة، وأن لهم الحق في نقض أي قرار يرونه مخالفا للدين الإسلامي، رغم أن هذا لم يرد حتى في هذا النص الدستوري المهلهل! وكما نعلم، فإن الدين أصبح طيعا بيدي الولي الفقيه، فما يراه حلالا حلال، وما يراه حراما حرام، فهو “نائب الإمام المنتظر وولي أمر المسلمين”، وهذا يعني أن كل شيء في الدولة العراقية سيكون رهن إشارة الولي الفقيه! فإن لم ترُق له نتائج الانتخابات، فإنه يأمر ممثله في المحكمة الاتحادية بعدم التصديق على النتائج، وإن لم يعجبه تفسير مادة دستورية معينة، فيمكنه عبر هذه الآلية أن يفرض التفسير الذي يخدم مصلحة النظام الإيراني، وبذلك يتحول العراق فعليا إلى ولاية قلقة تابعة للولي الفقيه الإيراني.
لا شك أن الدستور العراقي متناقض وغامض وصياغاته ضعيفة، وكاتب السطور أول من يعرف ذلك، إذ نظَّمت مؤتمرا في بغداد في مطلع أكتوبر عام 2005، قبل الاستفتاء على الدستور بأسبوعين، للتحذير من ضعف مواده وتناقضها، والدعوة لتلافي الهفوات في النص النهائي. وشارك في المؤتمر فقهاء في القانون والدين وسياسيون ومنظمات مجتمع مدني، وحضره مئات الناشطين على مدى ثلاثة أيام.
ولكن، ألا يجدر بالنواب، إن كانوا حقا يمثلون العراق، ويحرصون على مصالحه، النظر إلى مصلحة العراق عند تشريع القوانين، من أجل تعزيز استقلال البلاد وضمان العدالة وسيادة القانون، بدلا من استغلال المواد الدستورية من أجل إضعاف الدولة وتعريض سيادتها واستقرارها للخطر، خدمة لأيديولوجية ثيوقراطية مرفوضة عراقيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، تتبناها دولة معزولة إقليميا ودوليا؟ إن مطاطية مواد الدستور يجب أن تكون فرصة يغتنمها الوطنيون للانتصار للدولة العراقية وتعزيز قوتها ومكانتها الدولية، وتأكيد مصالح شعبها، وليس مناسبة لإضعاف الدولة وزعزعة استقرارها، والإخلال بالعدالة وسيادة القانون.
هناك معارضة شديدة في البرلمان والشارع لمحاولات الجماعات الموالية لإيران العبث بتشكيل المحكمة الاتحادية، التي يجب أن تكون مستقلة بنص الدستور، ولكن هناك أيضا خشية من أن يدخل المعارضون في صفقات لتمرير مشروع القانون هذا، مقابل تمرير قانون آخر، كقانون موازنة عام 2021 الذي لم يمرر بعد ثلاثة أشهر من المداولات، بسبب الخلاف حول حصة إقليم كردستان في الموازنة.
وقد حصل سابقا أن تواطأ النواب الأكراد مع الجماعات المتشدقة بالدين لتمرير قانون واردات البلديات عام 2016، علما أنهم يرفضونه ولا يطبقونه في الإقليم، لكنهم حصلوا على تنازلات مقابل تمريره. وسبب عدم اكتراث النواب الأكراد للقوانين الاتحادية هو أنهم في الإقليم لا يتأثرون بها، إذ يوجد نص دستوري يجيز لهم أن يشرعوا قوانين تخالف القوانين الاتحادية العراقية وفق المادة (121- ثانيا)، لذلك دأبوا على معارضة التشريعات من أجل تحقيق مكاسب وقتية محددة، متخلين عن معارضتهم حال تحقيق تلك المكاسب.
الرأي السائد في الشارع العراقي، والذي تدعمه الوقائع، أن البرلمان الحالي لا يمثل الشعب، ولهذا السبب رفضه الشارع منذ البداية وثار على حكومة عادل عبد المهدي التي تمخضت عنه، وهي الحكومة الأولى بعد 2003، التي لا يعرف أحد كيف شُكِّلت، وأيَّ كتلة نيابية دعمتها، وحتى رئيس الجمهورية، الذي كلَّف عبد المهدي بتشكيلها، بعث بكتاب رسمي إلى البرلمان بعد استقالتها يطلب فيه تحديد الكتلة الأكبر!
من أسباب الرفض الشعبي للوضع السياسي القائم أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الماضية لم تتجاوز 20% من الناخبين المسجلين، أي أن 80% من الناخبين قاطعوا الانتخابات لعدم إيمانهم بجدوى العملية السياسية في إحداث تغيير لصالحهم، وأن هناك تزويرا واسع النطاق وقع في انتخابات 2018، فاق التزوير الذي شاب الانتخابات السابقة، ومن نتائجه الغموض السائد حتى الآن حول الكتلة الأكبر. والسبب الأهم هو فشل النظام في حفظ الأمن وتحقيق الرفاهية وصيانة سيادة العراق، وإقدام المتنفذين فيه على نهب المال العام وقمع الرأي الآخر.
ومن هنا فإن أي قرار يتخذه البرلمان الحالي، خصوصا بوجود نوّاب ينتمون إلى جماعات موالية لإيران، لن يكون مقبولا شعبيا، ولن يهدّئ من الاحتجاجات المتصاعدة ضد هذا النظام الفاشل. إن لجوء الجماعات الموالية لإيران إلى إقحام الفقهاء في المحكمة الاتحادية، يهدف إلى فرض تركيبة ثيوقراطية تبقي وجودا سياسيا وثقافيا لها بعد إزاحتها عن السلطة فعليا. لكن مثل هذه التركيبة، لا تمتلك مقومات البقاء، لأنها مرفوضة ثقافيا وشعبيا، ولأنها تأتي على حساب الحرية والديمقراطية، ولأنها تلحق أضرارا سياسية واقتصادية فادحة بالعراق، وأن بالإمكان تعديل القانون حال تغير موازين القوى.
يبدو أن القوى الموالية لإيران تعيش في عالم منعزل عن الواقع، فالشارع منتفض ضدها وضد النفوذ الإيراني الذي جاء بها، لكنها، بدلا من تخفيف حدة خطابها وتقديم تنازلات للشعب، تواصل نهجها العدواني القائم على القتل والخطف والنهب المشرعن دينيا. كما أن تعاليها على الشعب، وتماديها في تجاهل الغضب الشعبي، وتشدقها بالدين، رغم إفلاسها الأخلاقي وفشلها السياسي، قد بلغت درجات تتحدى المنطق السليم، وساهمت في تشرذمها إلى جماعات تمارس القتل العشوائي ليس فقط ضد منتقديها بل ضد المواطنين العاديين.
قبل عام خطف “مجهولون” المحامي الشاب، علي جاسب، في مدينة العمارة. فظل والده المكلوم بتغييب ابنه يطالب بالكشف عن مصيره، حاملا صورته في التجمعات والأماكن العامة، ما أزعج الخاطفين بسبب تعاطف الناس معه، فقرروا إلحاق الأب بالابن، فقتلوه أثناء خروجه من مأتم لمغدور آخر! هذا الحادث الإجرامي أثار غضب العراقيين في عموم البلاد، وأجج المعارضة من جديد للجماعات المسلحة الموالية للولي الفقيه. ورغم أن وزارة الداخلية بثت فديو “يعترف” فيه شخص بأنه قتله لأسباب شخصية، فإن أحدا لم يصدق بهذا “الاعتراف” المقتضب وغير المتماسك.
تعديل القانون المحكمة الاتحادية لعام 2005، بدلا من إصدار قانون جديد، قد يقدم حلا للمأزق في هذه المرحلة الانتقالية. المادة الثالثة من القانون تنص على وجود تسعة أعضاء، ويمكن تعديلها كي تسمح للمحكمة بالانعقاد بالأعضاء الحاليين، وإناطة مهمة إكمال العدد بمجلس القضاء الأعلى لترشيح بدلاء للقضاة الغائبين، كي يصدر بتعيينهم مرسوم جمهوري. كما يجب تعديل المادة الخامسة من القانون كي تسمح بانعقاد المحكمة بغالبية الأعضاء، وليس بكامل الأعضاء، كما ينص القانون الحالي.
أما إقحام رجال دين متحزبين بين القضاة، ومنحهم حق النقض، فمن شأنه أن يقود إلى مزيد من الرفض الشعبي للجماعات المتشدقة بالدين، ويزيد الأوضاع المأزومة تفاقما. وكلما حاولت الجماعات الموالية لإيران السيطرة على الدولة، ازدادت المعارضة الشعبية لها، حدة وشراسة. وإن كانت المعارضة الشعبية الآن سلمية، فإن استمرار الاغتيالات وعمليات الخطف والنهب والإرهاب والتجويع سيضطر المحتجين إلى حمل السلاح دفاعا عن أنفسهم. والنصر سيكون حتما حليفا للشعوب، لا العصابات الإجرامية المرتبطة بدولة معادية.